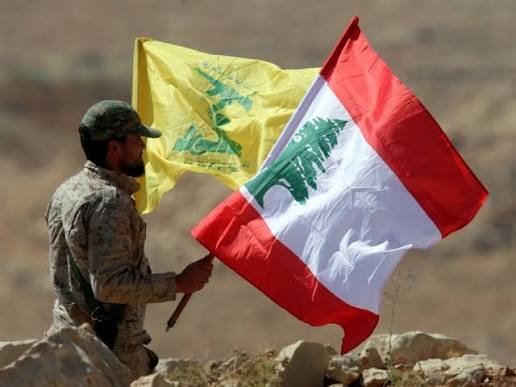على ناصية صاخبة من قلب القاهرة، حيث يلتقي شارع قصر النيل بشارع شريف، تقف عمارة الإيموبيليا شامخة كجبل من الحجر والأساطير. ربما تراها لأول مرة وتظن أنها مجرد مبنى عتيق من مباني وسط البلد، لكن ما إن تقترب منها حتى تعرف بأنك أمام ذاكرة مصرية كاملة؛ ذاكرة تحكي عن زمن كانت فيه القاهرة عاصمة للأنغام والشاشات والموهبة والترف.
ذاكرة للفن
بُنيت الإيموبيليا بين عامي 1938 و1940، وقتها لم تكن مجرد مبنى سكني، بل كانت مشروعًا يعكس روح مصر الحديثة آنذاك. فقد كانت البلاد في أوج انفتاحها على العالم، والفن يملأ المقاهي والمسارح، والسينما المصرية تتجه لتصبح واحدة من أهم الصناعات في الشرق الأوسط.
وفي تلك اللحظة التاريخية بالذات، جاء أحمد عبود باشا، رجل الصناعة والمال، ليبني ما سيصبح أول ناطحة سحاب سكنية في وسط العاصمة، مستعينًا بالمهندسين ماكس إدري وجاستون روسي، لتخرج العمارة في شكل هندسي مهيب يشبه حرف U، بارتفاع يصل إلى نحو 70 مترًا، وبـ 370 شقة كانت تُعد عنوانًا للرفاهية في الأربعينيات.
لكن العمارة لم تكتسب قيمتها من ارتفاعها أو تصميمها وحدهما. ما منح الإيموبيليا مكانتها الأسطورية هو من سكنها. كان باب العمارة يشبه بوابة مسرح كبير، وما إن تعبره حتى تجد نفسك داخل عالم يضج بالنجوم.
هنا عاش عبد الحليم حافظ في سنواته الأولى، وفي طابق آخر لحّن محمد عبد الوهاب أجمل ألحانه، وفي شقة تطل على الشارع الهادئ، كانت ليلى مراد تستقبل ضيوفها الذين جاءوا ليستمعوا إلى صوتها العذب بلا ميكروفون. أما نجيب الريحاني، فكان من أكثر سكانها حضورًا، وكانت شقته ملتقى المبدعين والضاحكين وأهل المسرح.
كان سكان العمارة يمضون في ردهاتها كأنهم يسيرون فوق سجادة من الحكايات. فالمصعد الذي يفتح بابه أمامك اليوم هو نفسه الذي صعدت به أم كلثوم ذات ليلة لزيارة أحد أصدقائها. والدرج الخلفي الذي نادرًا ما يلاحظه الزائرون كان ذات مرة ممرًا سريًا يُفضله بعض الفنانين هربًا من المعجبين والصحافة. حتى الحارس كان شخصية لها احترامها، فهو لم يكن مجرّد حارس، بل بوابة الأسرار كلها، حافظ الحكايات التي لا تُروى.
الإيموبيليا والطبقة المتوسطة الجديدة
لم تكن العمارة مجرد عنوان للمشاهير، بل كانت رمزًا لصعود الطبقة الوسطى المتعلمة، ولجيل من المثقفين والفنانين الذين كانوا يرسمون ملامح الهوية المصرية الحديثة.
كل شرفة في العمارة شهدت جلسات سهر، حوارات، بروفات غنائية، ومشاهد من أفلام لم تُصوّر. من هنا خرجت أغانٍ حملناها جميعًا في الذاكرة، وأفكار شكلت وعي الجمهور، وصور لا تزال تضيء في ذاكرة السينما العربية.
لكن الزمن، كعادته، لا يمنح مكانًا مجده كاملًا دون أن يختبر قدرته على الصمود. بعد ثورة 1952 وتغيّر السياسات الاقتصادية، انتقلت ملكية العمارة من أصحابها الأصليين إلى جهات حكومية، وتحوّلت العديد من شققها الواسعة إلى مكاتب تجارية. ومع مرور السنوات تغيّر وجه المنطقة، وازدحمت الشوارع، واشتدت الضوضاء، ولم تعد الإيموبيليا ملتقى الأرستقراطية الفنية كما كانت.
بريق ينحسر
رغم كل التغيّرات الكبيرة التي شهدتها مصر، وتأثرت بها البناية الشهيرة، غير أنّ شيئًا ما، لا يزال هناك. فروح العمارة بقيت أقوى من تقلبات الزمن. لا يزال الداخل إليها يشعر بأن الزمن هناك يمشي بخطى مختلفة. الأرضيات الرخامية، المصاعد القديمة التي لا تزال تعمل، الممرات التي تشبه دهاليز المتاحف، كلها تعطي إحساسًا أنك تقف في فيلم قديم لكنك حي فيه.
في السنوات الأخيرة، عاد الاهتمام بالإيموبيليا من جديد. بدأ شباب شغوفون بالتراث العمراني يوثقون قصتها بالصور والفيديو، وتحول بعض شققها إلى فضاءات فنية أو استديوهات. استعاد الناس إعجابهم بنمط حياتها القديم، وبالقصص التي لا تزال تُروى عنها. حتى أن البعض يأتونها فقط لالتقاط الصور أمام مدخلها الذي شهد نجوماً وملوكاً وموسيقيين.
الإيموبيليا ليست عمارة يُنظر إليها كحجارة وزجاج، بل ككائن حي، أصابته الشيخوخة لكن ملامحه لا تزال جذّابة، مفعمة بكرامة التاريخ. هي ذاكرة القاهرة، التي ترفض أن تنسى أنها كانت يومًا أمّ الدنيا في الفن، والحلم، والحياة الاجتماعية الراقية.
وإذا مررت يومًا بوسط القاهرة، وتعبت من ضجيج السيارات، ارفع رأسك للحظة. انظر نحو تلك التحفة المعمارية العظيمة التي تقف بعناد منذ أكثر من ثمانين عامًا. ستجد أن جدرانها لا تزال تقول شيئًا…
تقول إن الجمال لا يموت، وإن الحكايات لا تنتهي، وإن القاهرة رغم ما تغيّر لا تزال قادرة على أن تُدهشك إن اقتربت منها بما يكفي.