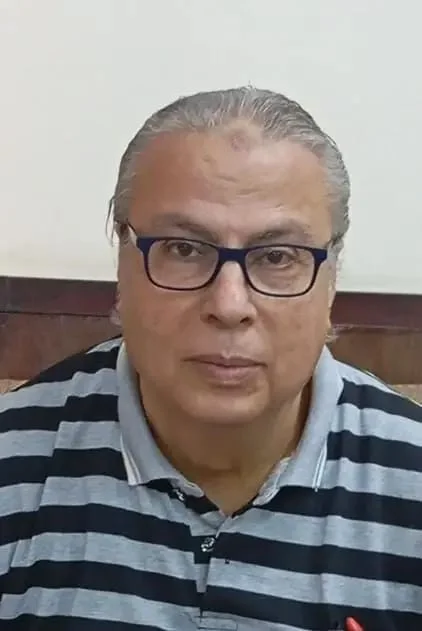لم تعد إدارة الدولة الحديثة أمرًا ميسورًا أو بسيطًا، فقد باتت تلك الإدارة أمرًا بالغ الصعوبة، وشديد التعقيد، نظرًا للمتغيرات الجمة التي طرأت على العالم كله، بعد أن وصل إلى مرحلة الانفجار المعرفي، وثورة الاتصالات، وتغير نمط العلاقات الدولية، والتنافس في الأسواق العالمية التي تسيطر عليها الرأسمالية الجديدة، وطغيان الحروب الاقتصادية الضارية، ناهيك عن التنافس الدولي المحموم في إنتاج أسلحة تفوق الخيال، التي يمكن لها في لحظة طائشة وبضغطة على زر واحد أن تكتب الفناء لكل ما هو حي على ظهر الكرة الأرضية.
ومن ثم أدركت الدول الكبرى مبكرًا قيمة البحث العلمي الذي يصنع لها السطوة والهيمنة والتفوق، في الوقت الذي وقفت فيه دول أخرى وقفة المشاهد، مكتفية، بإبداء شعورها بالانبهار والدهشة مما يحدث هناك في الغرب، وربما تأخذ ببعض صور مؤسساته ومراكزه العلمية، دون فلسفة عميقة، أو رؤية واضحة لإقامة مراكزها العلمية، التي تكاد حكومات هذه البلدان لا تعتمد عليها إلا اعتمادًا صوريًا محدودًا، بينما تزدحم أضابير هذه المراكز بأبحاث سجينة، لو خرجت وعرفت طريقها إلى مواقع صانعي السياسات، أو عرف صانعو السياسات الطريق إليها، وقدروها حق التقدير، وانتقوا منها ما يتفق وواقع البلاد، لتحولت الحال، ولتقدمت المواضع، ولوجدت هذه البلاد موضعًا رفيعًا وسامقًا وسط تلك البلاد الأخرى، بل تنافسها كتفًا بكتف، وذراعًا بذراع، غير إن الناظر إلى مراكز البحث العلمي لدينا وعلاقتها بصناع القرار سرعان ما يكتشف إنها علاقة شبه مفقودة، وهي شكوى كثرما باح بها علماؤنا وباحثونا في هذه المراكز، فما فائدة البحوث العلمية في شتى مجالات الحياة ما لم توضع موضع التطبيق والتنفيذ؟! فالبحث العلمي ليس ترفًا ولا تسلية، ولكنه عمل شاق ومضنٍ، تنتج عنه رؤى مبدعة وخلاقة لبناء الأمة والرقي بها، من خلال التواصل الحقيقي بينها وبين من بيدهم استثمارها الاستثمار الأمثل، وإن أخطر شيء أن تضيع جهود الباحثين سُدًى، مما يدفع ببعضهم إلى الهجرة الخارجية، فليس هناك أصعب من شعور باحث علمي جاد باليأس والإحباط وهو يرى عمره الذي أنفقه في البحث العلمي قد تبدد، وأن جهده قد تم قبره في مقابر الإهمال والاستهانة وعدم التقدير، فينفق ما تبقى من سني عمره في مشاعر مختلطة مشحونة بأسئلة حائرة لا يجد لأي منها إجابة.
إن المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وهي كثيرة ومعقدة، لا يمكن حلها بمعزل عن التعاون الوثيق بين أجهزتها ومراكز أبحاثها في كل مجالات البحث: الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والاقتصاد والاجتماع، وليكن هناك وشائج قوية تُعلي من المصلحة الوطنية وتضعها الهدف الأوحد والغاية البعيدة، ولا ننسى أن الكيان الصهيوني بادر بعد عامين فقط من إبرامه لاتفاقية السلام مع مصر عام 1979م، وفي عام 1982م، إلى إنشاء مركز البحوث الإسرائيلي في قلب القاهرة وفي حي الدقي على ضفاف النيل، ولم يسع هذا الكيان هذا المسعى إلا جادًا في التغلغل في أعماق المجتمع المصري تحت زعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي المشترك، بينما هو في حقيقته البوابة الخلفية الواسعة لممارسة نشاطه الموسادي التجسسي، وهو ما كشفت عنه أجهزة المخابرات المصرية قرابة ثلاث مرات بالقبض على شبكات تجسس تضم بين أعضائها باحثين في هذا المركز الإسرائيلي في أعوام (1985 و1986 و1989)، وكان من أخطر الأبحاث التي قام بها هذا المركز الصهيوني بحث يتعلق بالأصول العرقية للمصريين، وهو بحث ليس له إلا هدف واحد هو زرع الفتنة بين أبناء الوطن لتجزئته، وتفتيته، وتمزيق شمله، والجدير بالذكر أن جامعاتنا المصرية رفضت منذ اللحظة الأولى التعاون البحثي المزعوم مع هذا الكيان الخبيث، الذي لم يلق أي دعم أو تعاون من بين جموع الباحثين والمفكرين والكتاب المصريين إلا من عدد ضئيل للغاية من مؤيدي عملية السلام مع الكيان الصهيوني، ويخامرني شك أقرب إلى اليقين أن كثيرًا من الظواهر الاجتماعية السلبية التي طرأت على المجتمع المصري كانتشار إدمان المخدرات، والعنف والتطرف الديني ونزعات الطائفية، ما كان لبعضها أن يظهر، وما كان لبعضها أن يقوى ويمسك بتلابيب المصريين إلا بنشاط ذلك المركز الصهيوني في مصر. وليس هناك أي مواطن مصري يقتنع بأية حال من الأحوال أن الكيان الصهيوني يبتغي أي لون من الخير لمصر في زراعتها وصناعتها وتعليمها واقتصادها، ومن ثم علينا أن ندرك، ونحن في سفينة تتلاطمها أمواج عالية عاتية من كل جانب تنشد الوصول إلى مرافئ الأمان قبل أن تحطمها العواصف، أن تؤم الدولة المصرية وجهها نحو مراكزها البحثية، ولا تلتفت عنها قيد أُنملة، إذ هي القادرة على دراسة واقعنا وتحدياته والتخطيط الأمثل لعلاج مشاكله بأسلوب علمي رصين، يمد سياسيينا بأفكار خارج الصناديق البالية والمتكررة والتي تم تدويرها عبر حقب طويلة ومتوالية فلم تُجدِ شيئًا، بل تزيد حياتنا تعقيدًا وتزيد واقعنا ألمًا.
إننا في عالم تقطع فيه دول أشواطًا من التقدم بفضل اعتمادها على مراكزها البحثية الجادة، وإن أي حكومة من الحكومات مهما بلغت مهارة وزرائها وذكاؤهم، فلن تستطيع أن تحقق مصالح الوطن على النحو المأمول ما دامت تعطي ظهرها لمراكز البحث العلمي، وتستهين بأدواره في صناعة النهضة والخروج بالوطن من مخانق أزماته التي تقف وراءها الفردية وضيق الرؤية والنرجسية في التخطيط. فإذا عرفنا أن مصر الغنية بعلمائها ومفكريها قد نشرت مراكزها البحثية (116000) بحث علمي ما بين عامي 2019م و2024م، فيتحتم علينا أن نسأل سؤالًا بريئًا يستوجب الإجابة عليه بشفافية مطلقة، وهو: (أين أثر هذه الأبحاث في علاج أزماتنا المتراكمة والمعقدة في التعليم والاقتصاد والقضايا الاجتماعية؟!!!