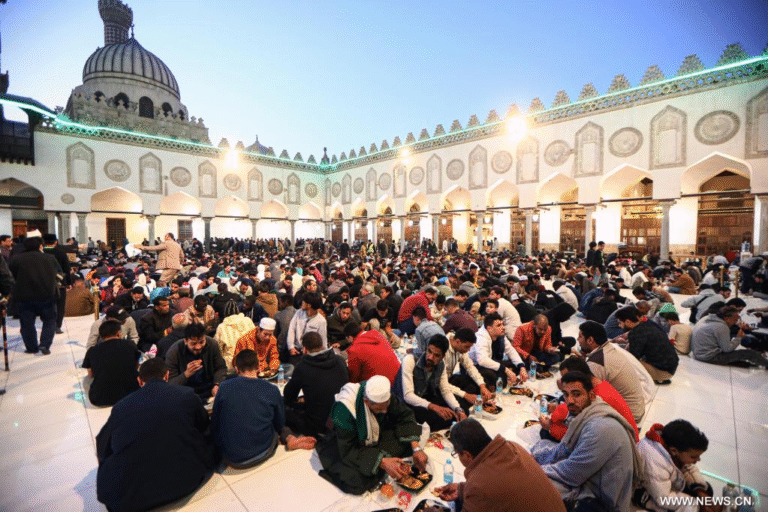رجلٌ مُعبّأ بتقاليد وعادات وتراث شعبي تربّى عليه؛ تقبّله أو ترفضه، فهذا حقك. وبنتٌ من مجتمع آخر وعالم مغاير، اختلفا على جلستها في حافلة عامة؛ هو يرى أنها خارجة على التقاليد، وهي ترى أنها حرة تجلس كيف تشاء، وصفها بسوء الأدب، ووصمته بالجنون، التقطتهما كاميرا عابرة أو مترصدة، فصارا حديثًا بدأ ولم ينتهِ.
هو رجل عابر، وهي سيدة لم ترصد الكاميرا وجهها.
كان الحدث سيمر لولا حالة الاستقطاب البلهاء والفراغ البشع، فانقلب الأمر إلى حديث أهلي وزمالك.
في اليوم نفسه، كان هناك إعلاميان من فريق واحد يتقاذفان الحديث عن حرية الرأي والتعبير على منصة ذائعة الصيت؛ يرى أحدهما أنه لا سجناء رأي، وأن المحبوسين خلف قضبان السجون يستحقون ما هم فيه، إذ إنهم – من وجهة نظره – ينشرون مناخًا تشاؤميًا. بينما يرى صديقه أن الرأي يظل رأيًا، حتى لو كان ما يُقال قدحًا صرفًا.
أين المشكلة إذن؟
المشكلة أن الزملاء من قادة الرأي في صحافتنا تركوا ما يلوكه “الصحفي الإعلامي” في وجوه الجميع دون اعتراض أو تعليق أو رد، وانبروا يهاجمون العجوز المسن الغريب، وأشبَعوه نقدًا وسبًّا وقذفًا، حتى إن أحد رؤساء إحدى الروابط الصحفية كتب محرّضًا على تقديم بلاغ فوري ضد هذا “الكائن” – أي والله – نزع عنه صفة الإنسانية، ويرى أن أمثاله مكانهم السجن والمحاكمة!
أما الأخرى، فترى أن المتعاطفين مع الرجل أو المتفقين معه مرضى نفسيون يجب أن يزوروا الطبيب النفسي لعلاجهم مما هم فيه، دون حتى لوم السيدة، لا على جلستها – فهي حرة فيها – بل على بذاءة ردّها على رجل في مثل سن أبيها، خانته قرويته وعادات يُسلِّم بها.
مشكلتنا أننا نختار المعارك الآمنة، ونجري – إن لم نكن نسبق – العامة في اصطياد لقطة لن ندفع ثمنها، ولا نتصدى لمعـارك هي صلب عملنا ووسيلة رُقينا وتقدمنا، إذا ما أنجزناها أو حتى قطعنا فيها شوطًا يقرّبنا إلى حريتنا، وحرية المجتمع في أن يفعل ما يروق له، طالما ظل ذلك في حدود المصلحة العامة للناس، هنا في الحضر أو هناك في الريف.